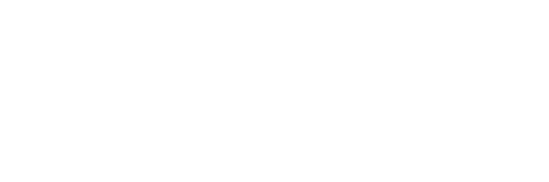كلمة للشيخ عبدالله العقيل رحمه الله في الامام أحمد بن حنبل رحمه الله
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي، وشيبان حي من بكر القبيلة المشهورة من قبائل العرب. ولد في ربيع الأول على المشهور سنة 164 هجرية في بغداد، وكانت أمه قد حملت به في مرو التي كان يقيم فيها أبوه، والمعروف أن أباه مات بعد ولادته عن ثلاثين سنة تقريبًا، وأحمد إذ ذاك صغير لا يدرك شيئًا بدليل أنه نفى رؤيته لأبيه وجده، وكان جده قد انتقل إلى خراسان، وكان واليًا على سرخس في العهد الأموي، ثم انضم إلى صفوف الدعوة العباسية حتى أُوذي في هذا السبيل، ويقال: “إنه كان قائدًا”. نشأ أحمد رضي الله عنه يتيمًا، وقامت على تربيته أمه صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني، وترك له أبوه بيتًا في بغداد يسكنه، وبيتًا آخر يُغِلّ غلة ضئيلة، وكان في هذا كشيخه الإمام الشافعي في اليتم والفقر والحاجة وعلو الهمة. تشابهت نشأة التلميذ والأستاذ، ولكل منهما أمّ تدفعه إلى التقدم والعلو والزيادة من الخير. نشأ الإمام أحمد رضي الله عنه ببغداد، وتربى فيها تربيته الأولى، وقد كانت بغداد إذ ذاك تموج بالناس الذين اختلفت مشاربهم، وتخالفت مآربهم، وزخرت بأنواع العلوم والمعارف، ففيها القراء والمحدثون والمتصوفة وعلماء اللغة والفلاسفة وغيرهم، فقد كانت حاضرة العالم الإسلامي، وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم من تنوع المسالك، وتعدد السبل وتنازع المشارب ومختلف العلوم، حتى إذا أتم حفظ القرآن، وعلم اللغة اتجه إلى الديوان ليتمرن على التحرير والكتابة، ولقد قال في ذلك: “كنت وأنا غُلَيم أختلف إلى الكُتَّاب، ثم أختلف إلى الديوان، وأنا ابن أربع عشرة سنة”، وكان وهو صبي محل ثقة الذين يعرفونه من الرجال والنساء، حتى إنه ليروى أن الرشيد وهو بالرقة مع جنده، وكان أولئك الجند يكتبون إلى نسائهم بأحوالهم، فلا يجد النساء غير أحمد يقرأ لهن ما كتب به إليهن، ويكتب لهن الردود، ولا يكتب ما يراه منكرًا من القول… شب أحمد على هذا، واستمر في طلب العلم بعزم صادق وجد، وأمه تشجعه على ذلك، وترشده وتدعوه إلى الرفق بنفسه إذا خشيت عليه الإرهاق، وحكى ذلك أحمد عنها فقال: “كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي، وتقول: اصبر حتى يؤذن الناس، أو حتى يصبحوا”، وكان اتجاهه إلى الأخذ عن رجال الحديث. ويروى أن أول تلقيه كان على القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد قال: “أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف”، وفي تاريخ الحافظ الذهبي قال الخلال: “كان أحمد قد كَتَبَ كُتُبَ الرأي، وحفظها، ثم لم يلتفت إليها”. اتجه أحمد إلى كتابة الحديث من سنة 179 حينما كان عمره ست عشرة سنة، واستمر مقيمًا في بغداد يأخذ عن شيوخ الحديث فيها حتى سنة مائة وست وثمانين، وابتدأ في هذه السنة رحلته إلى البصرة، ثم إلى الحجاز، واليمن وغيرها، واستمر ملازمًا لشيخه هشيم بن بشير بن أبي خازم الواسطي حتى سنة وفاته 183. قال صالح بن أحمد: قال أبي: “كتبت عن هشيم سنة 179، ولزمناه إلى سنة ثمانين وإحدى وثمانين واثنين وثمانين وثلاث، ومات في سنة ثلاث وثمانين، كتبنا عنه كتاب الحج نحوًا من ألف حديث وبعض التفسير، وكتاب القضاء، وكتبًا صغارًا، فقال صالح: يكون ثلاثة آلاف، قال: أكثر، ثم ارتحل في طلب العلم إلى الحجاز وغيره، وقد ذكر ابن كثير تفصيل رحلاته الحجازية في تاريخه” (البداية والنهاية:10/ 326). وكان من أبرز الشخصيات التي التقى بها الإمام أحمد أثناء رحلاته وفي إقامته: الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقد أخذ عنه، واستفاد منه كثيرًا، وكان الشافعي يجله ويقدره ويعول عليه في معرفة صحة الحديث أحيانًا، ورشَّحه الإمام الشافعي عند الرشيد لقضاء اليمن، فأبى أحمد، وقال له: “جئت إليك لأقتبس منك العلم تأمرني أن أدخل لهم في القضاء”، وكان ذلك في آخر حياة الرشيد، ثم رشحه الشافعي مرة ثانية لقضاء اليمن عند الأمين، فأبى أحمد، وكان ذلك 195 هـ. ودخل الشافعي يومًا على أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد الله كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع أحمد إليه ثلاثة أحاديث، فقال له: جزاك الله خيرًا، وقال الشافعي لأحمد يومًا: “أنتم أعلم بالحديث والرجال، فإذا كان الحديث الصحيح فعلموني إن شاء يكون كوفيًا أو شاميًا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا”، وهذا من كمال دين الشافعي وعقله حيث سلَّم هذا العلم لأهله. وقال عبد الوهاب الوراق: “ما رأيت مثل أحمد بن حنبل”، قالوا له: وأي شيء بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت؟ قال: “رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال (أخبرنا) و(حدثنا)”. وقال أبو زرعة الرازي: “حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة عليَّ سبعمائة ألف حديث”، وفي لفظ آخر قال أبو زرعة الرازي: “كان أحمد يحفظ ألف ألف”، فقيل له: وما يدريك؟ قال: “ذكراته فأخذت عليه الأبواب”. كان الإمام أحمد يقول: “فاتني مالك فأخلف الله عليَّ بسفيان بن عيينة؛ وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله عليَّ إسماعيل ابن عُلَيَّة”. وكان ملازمًا لكتابة الحديث فانشغل بذلك عن كل شيء حتى عن الزواج فلم يتزوج إلا بعد الأربعين. وقيل له: يا أبا عبد الله؛ قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، فقال: “مع المحبرة إلى المقبرة، فأنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر”. وقد روى المزني: أن الشافعي قال: “ثلاثة من عجائب الزمان: عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، وأعجمي لا يخطئ في كلمة وهو الحسن الزعفراني، وصغير كلما قال شيئًا صدقه الكبار وهو أحمد بن حنبل”. وقال الشافعي: “خرجت من بغداد ما خلَّفت بها أحدًا أورع، ولا أفقه، ولا أتقى، من أحمد بن حنبل”. ولم يزل على ذلك مكبًا على الحديث والإفتاء وما فيه نفع المسلمين، والتف حوله أصحابه يأخذون عنه الحديث والفقه وغيرهما، وألف المسند في مدة ستين سنة تقريبًا، وكان قد ابتدأ بجمعه في سنة 180هـ أول ما بدأ بطلب الحديث، وسيأتي الكلام على المسند إن شاء الله تعالى، وألف في التفسير، وفي الناسخ والمنسوخ، وفي التاريخ، وفي المقدم والمؤخر في القرآن، وفي جوابات القرآن، وألف المناسك الصغير والكبير، وفي حديث شعبة، وألف كتاب الزهد، وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وكتاب الصلاة، وكتاب السنة، وكتاب الورع والإيمان، وكتاب العلل والرجال، وكتاب الأشربة، وجزءًا في أصول السنة، وفضائل الصحابة، وله قصائد متناثرة، وأجزاء في بعض الأصول والمسائل، كما نقل عنه مجموعة من المسائل، منها مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني صاحب السنن، وهي مطبوعة نشرها السيد محمد رشيد رضا بمطبعة المنار، وتقع في 328 صفحة. وهي أجوبة على بعض المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد في الفقه؛ ومنها مسائل ابنه عبد الله بن أحمد، ومسائل إسحاق بن إبراهيم رواية ابن منصور المروزي وهي مخطوطة وتوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق وغير ذلك من مؤلفاته رضي الله عنه. كان في بغداد أيام المأمون تيارات ثقافية متضادة؛ منها: ما كان عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة الممثل في حلقات أهل الحديث والفقهاء وغيرهم ممن يرجعون إلى النصوص الشرعية. ويثبتون لله ما أثبته لنفسه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تأويل ولا تعطيل، ومن أبرز هؤلاء: الإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم. ومنها تيار المعتزلة القائلين بخلق القرآن وتأويل آيات الصفات وغير ذلك مما هو معروف من مذهبهم: كالقول بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان الرشيد يقاوم القول بخلق القرآن، فلم يجرؤ أحدٌ عليه مدة حياته، كما روي عن محمد بن نوح قال: سمعت هارون الرشيد يقول: “بلغني أن بشرًا المريسي زعم أن القرآن مخلوق، عليَّ إنْ أظفرني الله به لأقتلنه قتلةً ما قتلها أحد قط”، فلما مات الرشيد وتولى الأمين أراد المعتزلة حمله على ذلك فأبى. فلما تولى المأمون الخلافة، وكان يميل إلى المعتزلة ويقربهم، وكان أستاذه أبو الهذيل العلاف من زعماء المعتزلة، وكذلك قاضيه أحمد بن أبي دؤاد، فأشار عليه ابن أبي دؤاد بإظهار القول بخلق القرآن، فأظهر القول بذلك عام 212 هـ. فكان المأمون يناظر مَن يغشى مجلسه في ذلك، ولكنه لم يلزم بذلك أحدًا، بل ترك الناس أحرارًا فيما يذهبون إليه. فلما كان 218 هـ رأى المأمون حمل الناس وخصوصا العلماء والقضاة والمفتين على القول بخلق القرآن الكريم؛ وكان المأمون آنذاك في الرقة، فأرسل إلى واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم وهو صاحب الشرطة ببغداد أن يجمع مَن بحضرته من القضاة، ويمتحنهم فيما يقولون ويعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، ويعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله بمن لا يقول بهذا القول، وكان ذلك في ربيع الأول من عام 218 هـ. فثار العلماء حين سمعوا كتاب المأمون إلى نائبه في بغداد، وقال واحد منهم: “لقيت ثمانمائة شيخ ونيفًا وسبعين، فما رأيت أحدًا يقول بهذه المقالة -يعني: خلق القرآن-، وقد حبس وعذب وقتل في هذه المحنة خلائق لا يحصون كثرة، كما يراه القارئ المتتبع لتلك الحقبة من التاريخ، وصارت هذه المحنة هي الشغل الشاغل للدولة والناس خاصتهم وعامتهم، وأصبحت حديث مجالسهم وأنديتهم وحاضرتهم وباديتهم في العراق وغيره، وقام الجدل فيها بين العلماء، ووقع امتحان الأمراء للعلماء والقضاة والفقهاء والمحدثين في مصر والشام وفارس وغيرها، حتى تناول الإمام البخاري وشيوخه الأجلة الأفذاذ: يحيى بن معين وعلي ابن المديني ويزيد بن هارون وزهير بن حرب، وغيرهم من الأئمة المجمع على جلالتهم وإمامتهم في حفظ السنة المطهرة وعلومها. وأرسل المأمون لصاحب الشرطة في بغداد بأن يوافيه بجواب مَن امتحن منهم، فوافاه بجوابهم، وإذا هو يتضمن إنكار هذه المقالة، والتشنيع على مَن قال بها، فلم يقتنع المأمون بذلك، فبعث إليه بكتاب ثانٍ يأمره فيه بإشخاص سبعة من المحدثين المشهورين في بغداد أو ثمانية، وهم: محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم، ويحيى بن معين، وزهير بن حرب، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن إبراهيم الدورقي؛ لكي يمتحنهم وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل. إلا أن ابن أبي دؤاد حذف اسم الإمام أحمد من القائمة لمعرفته بصلابته وشدته في هذا الأمر. ثم أمر المأمون بعد ذلك بحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح إليه في طرسوس، فحملا إليه بأغلالهما. فأما محمد بن نوح فمات في أثناء الطريق قبل أن يصل. وأما الإمام أحمد ومرافقوه، فبلغهم وفاة المأمون قبل وصولهم، فعادوا إلى بغداد، وألقي الإمام أحمد في الحبس. ويقال: إن أحمد دعا على المأمون، وكانت وفاة المأمون في عام 218. ثم تولى الخلافة المعتصم، وكان المأمون قد أوصاه بتقريب ابن أبي دؤاد، والاستمرار بالقول بخلق القرآن، وأخذ الناس بذلك. وكان أحمد في السجن فاستحضره من السجن، وعقد له مجلسًا مع ابن أبي دؤاد وغيره؛ وجعلوا يناقشونه في خلق القرآن، وأحمد يستدل عليه بالنصوص الواردة. ويقول لهم: “أعطوني دليلًا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفض المجلس ذلك اليوم دون شيء، وأمر المعتصم برده إلى السجن. وفي اليوم التالي أُحضر من السجن، وعقد المجلس وكان موقفه رائعًا جليلًا كموقفه في الأمس، ورغم المحاولات والمناقشات صمم الإمام أحمد على كلامه، وفشل القوم كفشلهم بالأمس. وانفض الاجتماع، ورُدَّ الإمام أحمد إلى السجن. وفي اليوم الثالث أُعيد انعقاد المجلس، وأُحضر الإمام أحمد من السجن، وأُعيدت المناقشة. وكان المعتصم عند عقد مجلس المناظرة قد بسط بمجلسه بساطًا، ونصب كرسيًّا جلس عليه وازدحم الناس إذ ذاك كازدحامهم أيام الأعياد، وكان مما دار بينهم أن قال للإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ فقال: “كلام الله غير مخلوق، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة:6]. قال: هل عندك حجة غير هذا؟ قال: “نعم؛ قول الله تعالى: {الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ} [الرحمن:1-2]، ولم يقل: خلق القرآن، وقال تعالى: {يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} [يس:1-2]، ولم يقل: المخلوق. فقال المعتصم: أعيدوه للحبس وتفرقوا. فلما كان من الغد جلس المعتصم مجلسه ذلك. وقال: هاتوا أحمد بن حنبل، فاجتمع الناس، وسمعت لهم ضجة ببغداد، فلما جيء به، وقف بين يديه والسيوف قد جُرِّدت والرماح قد ركزت والأتراس قد نصبت والسياط قد طرحت. فسأله المعتصم عما يقول بالقرآن. قال: “أقول: غير مخلوق، وأستدل بقوله تعالى: {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي…} [السجدة:13]”، قال: “فإن يكن القول من الله تعالى، فإن القرآن كلام الله”، وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة، فناظروه بحضرته ثلاثة أيام وهو يناظرهم، ويظهر عليهم بالحجج القاطعة، ويقول: “أعطوني دليلًا من كتاب الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم”، فقال المعتصم: قهرنا أحمد، وحلف ليضربنه بالسياط، وأمر الجلادين، فأُحضروا، ولما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال: ائتوني بغيرها. قال أبو عبد الله: “ثم صُيِّرت بين العقابين”، والعقابان بضم العين خشبتان يوضع بينهما الرجل ليجلد، قاله في “تاج العروس”، فعلق الإمام أحمد بالعقابين، ورفع حتى صار بينه وبين الأرض مقدار قبضة، قال أحمد: وشُدَّت يداي، وجيء بكرسي فوضع له -يعني: للمعتصم-، وابن أبي دؤاد قائم على رأسه، والناس أجمعون قيام ممن حضر، فقال لي إنسان ممن شهدني: خذ بنابي الخشبتين بيدك، وشُدَّ عليهما فلم أفهم ما قال. قال: فتخلعت يداي لما شددت، ولم أمسك الخشبتين، قال أبو الفضل -يعني: ابنه صالحًا-، ولم يزل أبي رحمه الله يتوجع منهما من الرسغ إلى أن توفي. قال أبو عبد الله فقلت: “يا أمير المؤمنين؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث…» الحديث (صحيح البخاري الديات [6878]، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات [1676]، سنن الترمذي الديات [1402]، سنن النسائي تحريم الدم [4016]، سنن أبي داود الحدود [4352]، سنن ابن ماجه الحدود [2534]، مسند أحمد بن حنبل [1/ 382]، سنن الدارمي الحدود [2298])، فبِمَ تستحل دمي وأنا لم آتِ شيئًا من هذا. يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل كوقوفي بين يديك، يا أمير المؤمنين راقب الله”. فلما رأى المعتصم ثبوت أبي عبد الله وتصميمه لان، فخشي ابن أبي دؤاد من رأفته عليه، فقال: يا أمير المؤمنين إن تركته قيل: إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله، أو أن يقال: غلب خليفتين فهاجه ذلك، وطلب كرسيًّا جلس عليه، وقام ابن أبي دؤاد وأصحابه على رأسه، ثم قال للجلادين: تقدموا، وجعل أحدهم يتقدم إلى الإمام أحمد، فيضربه سوطين، ثم يتنحى، ثم يتقدم الآخر، فيضربه سوطين، والمعتصم يحرضهم على التشديد في الضرب، ثم قام إليه المعتصم، وقال له يا أحمد: علام تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق فما تقول؟ فيقول أحمد: “أعطوني دليلًا من كتاب الله وسنة رسوله حتى أقول به”، ثم رجع المعتصم، فجلس فقال للجلاد: تقدم، وحرَّضه على إيجاعه بالضرب، ويقول: شدوا قطع الله أيديكم. قال أحمد: فذهب عقلي عند ذلك، فلم أَفُق إلا وقد أفرج عني، ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر فصليت، فقالوا: صليت والدم يسيل منك؟! فقلت: قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دمًا، وكان ذلك في رمضان سنة 218. ثم نقل أحمد إلى بيته واستقر فيه حيث لم يقوَ على السير، فلما برئت جراحه، وقوي جسمه خرج إلى المسجد، وصار يدرس في المسجد ويملي الحديث حتى مات المعتصم. فلما تولى الواثق منع الإمام أحمد من الاجتماع بالناس، وقال: لا تساكني في بلد أنا فيه، فأقام الإمام ببغداد مختفيًا لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها حتى مات الواثق، وذلك مدة خمس سنوات تقريبًا. فلما تولى المتوكل الخلافة سنة 232 بقيت المحنة قائمة خلال عامين من حكمه، ثم رُفعت سنة 234، وكانت قد بدأت من السنة الأخيرة من خلافة المأمون، وهي سنة 218، وانتهت في السنة الثانية أو الثالثة من خلافة المتوكل سنة 234، حيث أوقف المتوكل أخذ الناس بالمحنة. وأصدر إعلانًا عامًّا في كافة أنحاء الدولة نهى فيه عن القول بخلق القرآن، وتهدَّد مَن يخوض في ذلك بالقتل، فعم الناس الفرح في كل مكان، وأثنوا على سجايا الخليفة ومآثره، ونسوا شروره ورذائله، وسُمِعَ الدعاء له من كل جانب، وذكر اسمه مع اسمي الخليفتين أبي بكر وعمر وعمر بن عبد العزيز. وكان المتوكل يكره العلويين، ويسرف في مطاردتهم، فجعل المعتزلة يحيكون دسائسهم لدى الخليفة ضد الإمام أحمد، ويتهمونه بالجنوح إلى العلويين، وتتطور المحنة لتأخذ لونًا آخر، وتشتد الرقابة على الإمام أحمد، وامتدت أعناق أهل الفتنة، فاتهموا الإمام أحمد لدى الخليفة أنه يؤوي في بيته أحد العلويين ذوي القدر الخطير، ويثور الخليفة، فيرسل من فوره إلى بغداد لمفاجأة بيت الإمام أحمد والقبض على العلوي المزعوم. وفي ليلة من الليالي بعد أن نام الناس، وهدأت الحركة وأرخى الليل سدوله على بغداد الهادئة الساكنة سمع أحمد دقًّا عنيفًا على باب داره، فقام إلى الباب ففتحه، فإذا به أمام رجلين وامرأتين، أما الرجلان فهما مظفر حاجب عبد الله بن إسحاق نائب بغداد والآخر ابن الكلبي صاحب البريد. وأما المرأتان فمهمتهما هي مهمة البوليس النسوي في أيامنا هذه. قال مظفر: يقول لك الأمير: إن أمير المؤمنين كتب إليه أن عندك طلبته العلوي، وقال ابن الكلبي: نعم إنك تؤوي في بيتك علويًّا من أعداء أمير المؤمنين وقد جئنا لأخذه، فقال الإمام أحمد: إني لا أعرف هذا، ولا أرى سوى طاعة أمير المؤمنين في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة. وسكت الإمام قليلًا سكتة ذكر فيها حرمانه من المسجد بدون مسوغ، واستأنف يقول: إني أتأسف عن تأخري عن الصلاة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين، قال ابن الكلبي: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك ما عندك طلبته أفتحلف؟ قال أحمد: إن استحلفتني حلفت، فأحلفه ابن الكلبي بالله فحلف، وبالطلاق فحلف. وكان نساء الدار والصبيان قد حضروا، وحضر ابنه صالح، فقال ابن الكلبي: أريد أن أفتش منزلك ومنزل ابنك صالح، وقام مظفر وابن الكلبي، ففتشا البيت وفتشت المرأتان النساء، فلم يعثروا على شيء، وفتشا بيت صالح، فلم يجدا شيئًا، وفتشت المرأتان أماكن الحريم، وجاؤوا بشمعة فأدلوها في البئر، وانصرفوا بعد أن لم يجدوا شيئًا. وتولى ابن الكلبي وصف حال الإمام أحمد للمتوكل من احتباسه عن الجمعة والجماعة بدون مسوغ ومن صدق لهجته فيما يُكِنّ لأمير المؤمنين من السمع والطاعة في المنشط والمكره ومن براءته مما عزاه إليه خصومه، وأذن الله بانكشاف الغمة، فجاءه بعد يومين كتاب من علي بن الجهم أن أمير المؤمنين قد صح عنده براءتك مما قُذِفت به، وكان أهل البدع قد مدوا أعناقهم، فالحمد لله الذي لم يشمتهم بك. وأقبلت الخلافة على الإمام تخطب وُدَّه، وتطلب المؤانسة بقربه، والتبرك بدعائه، وأخذت الأيام تدبر مولية عن المعتزلة. فمرض ابن أبي دؤاد بالفالج، وجاء بعض أعيان الدولة يتقربون إلى الإمام أحمد بذكر ما نزل بابن أبي دؤاد، ويومئون إلى أن كرامة الإمام على الله؛ أوجبت ذلك القصاص، فلم يلتفت إليهم الإمام أحمد، وصمت، ولم يرد، وظهر عليه التبرم بما قالوا. ومضت الأيام في إدبارها على المعتزلة، فغضب الخليفة على ابن أبي دؤاد، وقبض على أبنائه، وصادر أملاكه وأمواله وجواهره، وأخذ ابن أبي دؤاد إلى بغداد بعد أن أشهد عليه ببيع ضياعه، فكان يأتي إلى الإمام أحمد من يحمل إليه تلك الأنباء، فيكرم نفسه أن تنزل إلى مستوى الشماتة الرخيص، بل كان الخليفة نفسه يرسل إليه كأنه يستفتيه فيما يرى من مصير أموال ابن أبي دؤاد، فكان يسكت ولا يجيب بشيء، وهو موقف جدير أن يلقي على الناس دروسًا في عظمة النفس وشدة الإقبال على جلائل الأمور، والانصراف عن سفاسفها وتوافهها، رحم الله الإمام أحمد، لقد كان إمامًا في كل مَكرمة. ثم أرسل إليه الخليفة المتوكل كتابًا يقول فيه: قد صح نقاء ساحتك، وقد أحببت أن آنس بقربك، وأتبرك بدعائك، وقد وجهت إليك بعشرة آلاف درهم معونة على سفرك، وفرح آل أحمد بالعافية تقبل مع السعة والجاه، وحل بالدار نشاط وأنس، ودبَّ فيها بعد الوحشة دبيب الحركة بمن صار يغشاها من رسل الخليفة وكبار رجال الدولة. قال ابنه صالح: لما جاء كتاب المتوكل بالمال ناداني أبي في جوف الليل، فقمت إليه، فإذا به يبكي، فلما رآني قال: ما نمت ليلتي هذه سلمت من هؤلاء حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم. فلما كان الصباح جاء الحسين البزاز والمشايخ فقال: يا صالح جئني بالميزان وبالدراهم، ثم أخذ يزن المال، ويقول: وجهوا هذا إلى أبناء المهاجرين، وهذا إلى أبناء الأنصار، وهذا لفلان ليفرق في ناحيته، وهذا لفلان، وهكذا حتى فرقها كلها، فلما فرقها أحس أنه فرق معها كربته وتنفس الصعداء ونفض الكيس، ثم تصدق به. وكان لا بد لأحمد من تلبية أمر الخليفة لا خضوعًا لقوة السلطان، بل وفاء لحق السمع والطاعة الذي فرضه الإسلام لأُولي الأمر في غير معصية، فخرج من بغداد إلى سامراء ومعه يعقوب المعروف بقَوْصرة، وهو الرسول الذي حضر إليه من لدن الخليفة بالمال والخطاب، وخرج معه بعض بنيه، وكان يعقوب شديد السرور بنجاح مهمته، فقد قبل أحمد بن حنبل أن يخرج معه، وكان يدرك مبلغ السرور الذي سيدخل قلب أمير المؤمنين بذلك. نزل الإمام بـ”سُرَّ مَن رَأَى” ضيفًا على أمير المؤمنين، ولم يكن للخليفة مِن هَمٍّ بعد أن عرف كل شيء عن أحمد إلا أن يرضيه، وأن لا يحمله علي شيء يكرهه. عرف الخليفة أن أحمد لا يقبل ماله، فلم يكن له بد من النزول على رغبته واحترام إرادته، ولكن لا بد من أن يصله في قرابته؛ فليكن المال لأهله وبنيه دون أن يعلم، وتَسَلَّم صالح ابنه بأمر الخليفة عشرة آلاف على الفور، مكان التي فرَّقها أبوه ببغداد على أبناء المهاجرين والأنصار وسواهم. وعرف رجال القصر لهفة الخليفة وشدة إقباله على أحمد وإكباره له، فأقبلوا عليه بمثل ما أقبل سيدهم، كُلٌّ يخطب وُدَّه، ويبتغي إليه المنزلة، ويحاول أن يسره بما يستطيع. أمر الخليفة أن تفرش الدار التي هُيِّئت له بالفرش الوثيرة، وأن ترتب له ومن معه من بنيه مائدة شهية واسعة، وأمر أن يقطع له ملابس فاخرة: طيلسان وقلنسوة وشارات رسمية من السواد الذي اختارته الدولة العباسية شعارًا لها. ويحضر يحيى بن خالد فيقول: إن الخليفة أمرني أن أصير لك مرتبة في أعلى، ويصير ولده المعتز في حجرك تؤدبه بما شئت من أدب القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء يحيى في اليوم التالي يدعوه أن يركب إلى دار المعتز، ويقول في لهجة مهذبة: تركب يا أبا عبد الله، فيقول الإمام أحمد: ذاك إليكم وكان يومًا مشهودًا في القصر، ألبسوه هناك الطيلسان، وما أمر له به الخليفة من ألوان الثياب والشارات، ويقول بعض الخدم: إن الخليفة كان مع أمه مستترين خلف ستار من ستور القصر، يرقب في خفاء ما يكون من أحمد، فلما رآه يدخل أخذته خفة وغشيته هزة من الفرح ولمع السرور في عينيه، وقال: يا أمه قد أنارت الدار بدخول أحمد. يقول ابنه صالح: لما عاد أبي من القصر إلى الدار التي أعدت له نزع عنه الثياب التي أنعم بها عليه. وجعل يبكي ويقول: “سلمت من هؤلاء منذ ستين سنة، حتى إذا كان في آخر عمري بُليت بهم، ما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام، فكيف بالخليفة الذي يجب نصحه من وقت أن تقع عيني عليه إلى أن أخرج من عنده؟!”، ثم التفت إلى الملابس وقال لابنه: “وَجِّه بهذه الثياب إلى بغداد لتباع، وحذارِ أن يشتري أحد منكم شيئًا منها”. أما الفُرُش الوثيرة الطرية فقد نحى نفسه عنها، وألقى بنفسه على مضرية خشنة له، ونظر إلى حجرة في جانب الدار، فأمر أن يحول إلى ركن منها، وأن لا يسرج فيها سراج قط، وأما المائدة فقد عافها فلم يدخل بطنه شيء منها وكانت شهية حافلة. وأخيرًا بلغ الضجر بالإمام أحمد كل مبلغ، وبرم بكل شيء، وزهد في كل شيء، ولم يعد أبغض إليه من أن يلقى رجال الخليفة، حتى كان يدعهم مع بنيه في الدهليز، ويقبل على صلاته ما شاء الله، وكان المرض ينزل به، فيراه عافية سابغة لما فيه من عافية احتجابه عنهم. اشتكت عينه مرة فلما برئت ضاق ببرئها، وقال لولده صالح: “ألا تعجب كانت عيني تشتكي فتمكث حينًا حتى تبرأ، ثم هي في هذه المرة تبرأ في سرعة. والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان أيام المعتصم وإني لأتمنى الموت في هذا، إن هذا فتنة الدنيا وكان ذاك فتنة الدين نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن”. وأما مرضه ووفاته فإنه مرض تسعة أيام قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: “استكملت سبعًا وسبعين سنة”، فحُمَّ من ليلته وهو محموم يتنفس تنفسًا شديدًا، وقال صالح: وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا اعتل. وجاء الفتح بن سهل إلى الباب ليعوده فحجبه، وأتى ابن علي بن الجعد فحجبه، وكثر الناس، فقال لي: أي شيء ترى؟ قلت: تأذن لهم، فيدعون لك، قال: أستخير الله تعالى، فأذن لهم، فجعلوا يدخلون عليه أفواجًا، ويسلمون عليه ويرد عليهم بيده، ويسألونه عن حاله، ويدعون له حتى تمتلئ الدار، ثم يخرجون ويدخل فوج آخر، وكثر الناس، وامتلأ الشارع، وأغلقنا باب الزقاق، وجاء رجل من جيراننا قد خضب فسُرَّ به، وقال: “إني لأرى الرجل يجيء شيئًا من السنة فأفرح به”، فدخل فجعل يدعو له فيقول أبي: ولجميع المسلمين. وجاء رجل فقال: تلطف لي بالإذن عليه؛ فإني قد حضرت ضربه يوم الدار، وأريد أن أستحله. فقلت له، فأمسك فلم أزل به حتى قال: أدخله، فأدخلته فقام بين يديه، وجعل يبكي، وقال: يا أبا عبد الله أنا كنت ممن حضر ضربك يوم الدار، وقد أتيتك فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك، وإن رأيت أن تحلني فعلتَ. قال: “على أن لا تعود لمثل ذلك” قال: نعم، قال: “فإني جعلتك في حل”، فخرج يبكي، وبكى من حضر من الناس، ثم قال: “وَجِّه فاشترِ تمرًا، وكفر عني كفارة يمين”، فأخبرته بأني قد فعلت، قال: “الحمد لله”. ثم قال: “اقرأ عليَّ الوصية”، فقرأتها فأقرها، وكنت أنام إلى جنبه، فإذا أراد حاجة حركني فأناوله، وجعل يحرك لسانه ولم يئنَّ إلا في الليلة التي توفي فيها، ولم يزل يصلي قائمًا أمسكه، فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه، ولم يزل عقله ثابتًا. وتسامع الناس بمرضه، وكثروا، وسمع السلطان بكثرة الناس، فوكل ببابه وباب الزقاق المرابطة وأصحاب الأخبار، ثم أغلق باب الزقاق حتى تعطل بعض الباعة، وحيل بينهم وبين البيع والشراء، وكان الرجل إذا أراد أن يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور، وربما تسلق، وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأبواب، وجاءه صاحب ابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك، فقال: هذا مما أكرهه وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره، وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكر. والبُرُد تختلف كل يوم، وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون، وجاء قوم من القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم، فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين، قال: “ادعوا لي الصبيان” بلسان ثقيل، فجعلوا ينضمون إليه، وجعل يشمهم ويمسح بيده على رؤوسهم، وعينه تدمع، فقال له رجل: لا تغتم لهم يا أبا عبد الله، فأشار بيده فظننا أن معناه: إني لم أرد هذا المعنى. وكان يصلي قاعدًا، ويصلي وهو مضطجع، لا يكاد يفتر، ويرفع يده في إيماء الركوع، واشتدت علته يوم الخميس، ووضأته فقال: “خَلِّل الأصابع”، وثقل ليلة الجمعة، فلما كان يوم الجمعة الموافق اثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام 241 توفي صدر النهار لساعتين منه، فصاح الناس، وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت، وامتلأت السكك والشوارع، وقال صالح: وَجَّه ابنُ طاهر -يعني: نائب بغداد- بحاجبه مظفر، ومعه غلامين معهما مناديل فيها ثياب وطيب، فقلت: أقرئ الأمير السلام، وقل له: إن أمير المؤمنين قد كان أعفاه في حياته مما كان يكره، ولا أحب أن أُتْبِعه بعد موته بما كان يكرهه في حياته. وقد كانت الجارية غزلت له ثوبًا عشاريًا قُوِّم بثمانية وعشرين درهمًا؛ ليقطع منه قميصين، فقطعنا له لفافتين، وأخذ منه فوران لفافة أخرى، فأدرجناه في ثلاث لفائف، واشترينا له حنوطًا، وفرغ من غسله وكفناه، وحضر نحو مائة من بني هاشم ونحن نكفنه، وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير، وقال صالح: وَجَّه الأمير ابن طاهر فقال: من يصلي عليه؟ قلت: أنا، فلما صِرْتُ إلى الصحراء إذا ابن طاهر واقف، فخطا إلينا خطوات، وعزانا ووضع السرير، فلما انتظرت هنيهة تقدمت، وجعلتُ أسوي صفوف الناس، فجاءني ابن طاهر، فقبض هذا على يدي ومحمد بن نصر على يدي، وقالوا: الأمير. فمانعتهم فنحياني وصلى، ولم يعلم الناس بذلك، فلما كان من الغد علم الناس، فجعلوا يجيئون ويصلون على القبر، ومكث الناس ما شاء الله يأتون فيصلون على القبر، فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة، سوى ما كان في الأطراف والحواري والسطوح والمواضع المتفرقة، ومن كان في السفن في الماء، وقد حزر من حضر جنازته فكانوا سبعمائة ألف، وقيل: ثمانمائة ألف، وقيل: بلغوا ألف ألف وثلاثمائة ألف، وقيل غير ذلك مما يدل على أنهم جمع غفير، وكان رضي الله عنه يقول في حال صحته: “قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز”. وقد صنفت في ترجمته مصنفات مستقلة منها: “المناقب” لأبي الفرج ابن الجوزي في مجلد، ومنها لأبي إسماعيل الأنصاري في مجلدين، ومنها لأبي بكر البيهقي في مجلد، ومنها لأبي زهرة مجلد، ومنها لأحمد الدومي في مجلد، وغير ذلك عدا ما في غضون كتب التاريخ والتراجم من ذكر مناقبه وثناء الناس عليه رحمه الله وسائر أئمة المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم